قوة
الأحكام الجنائية أمام المحاكم المدنية
أثر الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية:
يتناول بحثنا في هذا الموضوع بيان المسائل الآتية:
الأولى: فقه المحاكم المصرية فيه.
الثانية: آراء علماء القانون الفرنسي وفقه المحاكم الفرنسية.
الثالثة: مذهب القانون المصري وكيف يجب تطبيقه في هذا المقام.
1 - فقه
الأحكام المصرية
قد يندفع
المترافعون مع مصلحتهم فيرى كل منهم أن هذه مسألة بسيطة، الرأي الصحيح فيها ما كان
موافقًا لطلباته، فإذا عثر على حكم يؤيد رأيه قال إن هذا ما أجمعت عليه الأحكام،
وفي هذا من النقص في البحث وتعقيد مأمورية القاضي ما لا يسهل معه [(1)]
وجهها الصحيح.
الواقع أن المسألة دقيقة معقدة، وقد اختلفت فيها الأحكام اختلافًا بينًا، بل قد
اختلفت فيها الدائرة الواحدة، فقضت برأي ثم عدلت إلى نقيضه.
في 31 أكتوبر سنة 1901 قررت محكمة الاستئناف (دائرة المستر بوند) أن الحكم الجنائي
لا أثر له أمام المحكمة المدنية وهذا نص أسباب الحكم حرفيًا:
(حيث إنه لا يوجد نص في القانون يقضي بجعل المحاكم المدنية مرتبطة بالأحكام
الصادرة من المحاكم الجنائية فيسوغ إذن لهذه المحكمة أن تنظر في دعوى تزوير العقد
بالطرق المدنية).
(وحيث إن عبد الحافظ محمد أحد المستأنفين لم يطلب من هذه المحكمة الحكم بتعويض كما
طلب أمام محكمة الجنح بصفته مدعيًا بحق مدني بل إن غاية ما يطلبه هو تزوير العقد)
(المجموعة الرسمية السنة 4 عدد (15) صحيفة نمرة 37 – 39).
ظاهر من هذا البيان أن واقعة الدعوى التي صدر فيها الحكم أن دعوى التزوير الجنائية
كانت قد تعلقت أمام القضاء الجنائي وأن النزاع فيها كان منظورًا بين المتمسك
بالعقد وبين المدين فيه، وكان هذا الأخير داخلاً في الخصومة مدعيًا بحق مدني، فصدر
الحكم بالبراءة في وجه الخصمين، ثم لما جاء دور المرافعة المدنية طعن المحكوم ضده
بالتزوير مرة أخرى أمام المحكمة المدنية فقررت محكمة الاستئناف أن الحكم الجنائي
الصادر في الدعوى العمومية وفي الدعوى المدنية معها لا قيمة له أمامها، لا لأنه
صادر بالبراءة وأحكام البراءة هي وحدها التي لا يحتج بها أمام المحاكم المدنية كما
يقول البعض استدلالاً بأقوال علماء القانون الفرنسوي، بل بناءً على ذلك المبدأ
العام المقرر في الحكم بكل جلاء ووضوح وهو استقلال كل من القضائين الجنائي والمدني
عن بعضهما استقلالاً لا يجعل لأحكام أحدهما أثرًا أمام الثاني لاختلاف الخصومة
موضوعًا وسببًا، وإذا رجعنا إلى هذا المبدأ الأصلي في تحديد أركان الأحكام
الانتهائية فلا فرق بين أحكام البراءة وأحكام العقوبة.
في سنة 1904 عرض الموضوع نفسه على جلسة أخرى (دائرة سعد زغلول) فذهبت إلى نقيض ما
ذهبت إليه الدائرة السابقة، بل وبالغت في الرأي إلى حد الاحتجاج بالحكم الجنائي
أمام المحكمة المدنية وخضوع هذه المحكمة له وأن صدر بالبراءة خضوعًا مطلقًا في
جميع تقريراته، حتى في ما خرج عن اختصاص المحكمة الجنائية كالتقرير بصورية العقد.
غير أن هذا الحكم وحيد في نوعه بل لا نجد له مثيلاً لا في الأحكام الأفرنسية ولا
في آراء العلماء هناك فإنهم يرجحون كما سنرى الارتباط بالحكم الجنائي إذا صدر
بالعقوبة، أما حكم البراءة فلا يعتد به، ثم إنهم مع اتفاق جمهورهم على هذا المبدأ
يحددونه بأن يكون ما حكم فيه القاضي الجنائي داخلاً ضمن اختصاصه المحدد بوقائعه
المعروفة وليست صورية العقد منها.
في 13 فبراير سنة 1909 عرضت المسألة على محكمة النقض والإبرام (رئاسة المستر بوند
أيضًا) فاضطرب رأيها في الموضوع، فقررت في الحكم مبدأ ثم خرجت في التطبيق عن قبول
نتائجه القانونية، لهذا رأينا الحكم لا يقبل من المدعي المدني الرجوع إلى دعوى
التزوير أمام محكمة الجنح بعد الحكم فيها مدنيًا بناءً على استقلال القضائيين، بل
قضى بأن المحكمة الجنائية يجب عليها أن تحترم الحكم المدني ولكن في علاقات الخصمين
المترافعين وحدهما فللحكم قوة الشيء المحكوم فيه فيما يختص بالحق المدني، أما فيما
يختص بالتزوير الجنائي وهو موضوع الدعوى العمومية فالحكم المدني لا أثر له بناءً
على استقلال القضائين فقبلت الدعوى العمومية وقضت بعدم قبول الدعوى [(1)].
قد يفهم أن هذا ليس عدولاً عن مبدأ الحكم الأول، لأن في قبول الدعوى العمومية
تأييدًا لاستقلال المحكمة الجنائية وعدم خضوعها لحكم المحكمة المدنية، وهذا معنى
استقلال القضائين عن بعضهما ذلك الاستقلال المقرر في حكم سنة 1901.
غير أن هذا خطأ لأن حكم سنة 1901 قبل النزاع المدني بين نفس الخصمين اللذين ترافعا
أمام المحكمة الجنائية وصدر الحكم في خصومتهما، وفي الموضوع المتفرع عن نفس الواقعة
التي كانت محلاً للمرافعة الجنائية فكان يجب على هذا أن تقبل مرافعة المدعي المدني
أمام المحكمة الجنائية رغمًا عن مرافعته أمام المحكمة المدنية فعدم قبول الدعوى
قيد من قيود الاستقلال الذي تقرر في الحكم الأول.
وأظهر من هذا أن المبدأ المقرر في حكم سنة 1901 إنما سببه القضائي اختلاف
الخصومتين أمام القضاء الجنائي والمدني موضوعًا وسببًا، فإن الخصومة الجنائية
موضوعها تعويض والمدنية موضوعها نفس الحق المدني المتنازع عليه في ذاته، وسبب
الخصومة الجنائية واقعة وسبب الخصومة المدنية رابطة قانونية مستفادة من عقد متنازع
فيه، ووضع النظرية على هذا الأساس – وهو أساس متين - يقتضي أن لا يكون للحكم
المدني أثر أمام المحكمة الجنائية.
على أن قبول الدعوى الجنائية بناءً على استقلال القضائين كان يترتب عليه حتمًا
قبول الدعوى المدنية لأن كل واقعة جنائية إذا ثبتت تقتضي حتمًا وبمجرد إثباتها حق
التعويض لمن وقعت عليه، وليس من الممكن أن يقرر القضاء أن جناية وقعت على زيد ثم
يقضي في الوقت ذاته أن المجني عليه لا تعويض له فليس من الجنايات ما لا يجوز تعويض
ضرره أو إزالة آثارها المدنية الظالمة.
الذي نفهمه أن لا جناية بغير مجني عليه وأن انعدام شخص المجني عليه يجعل الجناية
مستحيلة فالدعوى العمومية مستحيلة الوجود بل مستحيلة التصور لأنه لا يمكن تعليق
واقعتها في الهواء أو حصرها في حيز الفكر والوهم النظري.
لهذا قلنا إن الحكم مضطرب وما عنينا بشأن اضطرابه إلا بيانًا لخطورة المسألة
وأهميتها، وتعلقها بمبادئ عديدة قد يغيب على ذهن الباحث بعضها ويحضره البعض، فيثبت
رأيه على ما لا يوافق الأحكام المقررة في القانون أو المستفادة من مبادئه، ويكفي
مطالعة أسباب الحكم ليتبين كيف أن المسألة دقيقة وكيف أن هذه الأسباب تدل على عدم
اتفاق الحكم مع المبدأ الذي تقرر في حكم سنة 1901.
يقول الحكم ما نصه:
(وحيث إن هذه الدعوى قد توفرت فيها كافة الشروط المطلوبة لتطبيق مبدأ قوة الشيء
المحكوم فيه نهائيًا على الدعوى المرفوعة من المدعين بالحق المدني لأن الخصوم هم
أنفسهم في كل من الدعويين ويعتبر أن المطلوب في الدعويين واحد، والسبب فيهما واحد
أيضًا متى كانت الدعويان مختصتين بشيء واحد ولو اختلف وصفهما والمسألة المطلوب
الفصل فيها نهائيًا من المحكمة هي وذاتها مبنية على السبب ذاته. المجموعة الرسمية
سنة 10 صحيفة 167).
الفرق واضح بين هذا وبين قوله في حكم سنة 1901 أن المدعي لا يطلب من المحكمة
المدنية الحكم بتعويض كما طلب أمام محكمة الجنح، بل هو يطلب الحكم بتزوير العقد
نفسه مدللاً بذلك على اختلاف الخصومتين موضوعًا وسببًا، أما هنا فقد أصبحت
الخصومتان المختلفتان خصومة واحدة لمجرد تعلقهما بواقعة واحدة وهي الواقعة
الجنائية المطروحة أمام القضائين.
في 21 يناير 1913 حكمت محكمة الاستئناف (دائرة يحيى باشا) على خلاف حكم سنة 1901
وعلى خلاف حكم سنة 1909 من حيث المبدأ والنتيجة فقررت أن الحكم بالبراءة ترتبط به
المحكمة المدنية فيمنع من الرجوع إلى دعوى التزوير مدنيًا.
يقول الحكم ما نصه:
(وحيث بناءً على ذلك تكون تهمة التزوير قضي فيها نهائيًا والدعوى الحالية المطلوب
فيها إلغاء عقد الرهن ومحو التسجيلات المتوقعة مبنية فقط على الادعاء بتزوير هذا
العقد الذي يرجع فيه إلى الحكم الصادر في دعوى التزوير. مجموعة سنة 14 عدد (50).
عُرضت المسألة أخيرًا على محكمة النقض في أول يوليو سنة 1918 فأيدت من جديد مبدأ
حكم سنة 1901 القائل باستقلال القضائين، واختلاف الخصومتين موضوعًا وسببًا وعدم
جواز تقيد أحد القضائين بحكم الآخر ورجعت عن حكم سنة 1909 رجوعًا صريحًا.
جاء في حكم النقض ما نصه:
(وحيث بناءً على ذلك تكون الدعوى الحالية المؤسسة على الضرر المادي والأدبي الذي
لحق بالمدعي المدني أثناء سير القضية المدنية لسبب التزوير تعتبر دعوى يختلف
موضوعها اختلافًا تامًا عن دعوى المطالبة بالدين التي حكمت فيها المحكمة المدنية
كما أن القيمة المطالب بها في كليهما مختلفة أيضًا فلا يصح القول والحالة هذه بسبق
الفصل في دعوى التعويض الحالية. مجموعة سنة 20 عدد 2).
وإذا جاز بعد بيان أحكام محكمة الاستئناف وأحكام محكمة النقض والإبرام أن نذكر على
سبيل إتمام البحث ما نشر من أحكام المحاكم الابتدائية التي رأت إدارة المجموعة
نشرها لأهمية مباحثها، فإن في المجموعة حكمين صادرين من محكمة بني سويف بصفة
استئنافية وهذا بيان كل منهما.
حكم 6 يناير سنة 1910 جاء في بحث مطول ما نصه:
إن مبدأ قوة الشيء المحكوم فيه نهائيًا المنصوص عنه في المادة (232) مدني لا يمنع
من إقامة الدعوى العمومية مباشرةً لأن الأحكام المدنية فصلت في حقوق مختلف موضوعها
وسببها عن موضوع وسبب الحق المطلوب في الدعاوى الجنائية. مجموعة سنة 11 عدد 46).
وحكم 3 فبراير سنة 1912 جاء فيه ضمن بحث مستفيض أيضًا ما نصه:
(حيث إنه ليس يوجد في القوانين المصرية نصوص تشير إلى أن للأحكام الجنائية قوة
الشيء المحكوم فيه نهائيًا على الدعاوى المدنية المتفرعة من الجرائم مثل النصوص
الموجودة في القوانين الفرنسوية. المجموعة سنة 1913 عدد 118).
واضح إذًا من هذا أن فقه المحاكم وإن اعتراه شيء من الضعف والاضطراب، إلا أن أكثر
مظاهره ومعها حكم النقض والإبرام الأخير (يونيو سنة 1918) صريحة في تقرير مبادئ
الاستقلال بين السلطتين المدنية والجنائية، والاختلاف بين الخصومتين المدنية
والجنائية اختلافًا يلحق بالموضوع وبالسبب، وعلى هذا فلا يحتج أمام إحداهما بقوة
الشيء المحكوم فيه بناءً على حكم الأخرى، بل كل سلطة إنما تتقيد بالحكم الذي يصدر
منها، وكل سلطة حرة في بحث الموضوع المطروح أمامها من جديد كأنه لم يصدر فيه قضاء،
وذلك حتى بين الخصمين اللذين قامت خصومتهما أمام القضاء الجنائي ثم رجعا للمرافعة
أمام المحكمة المدنية أو بالعكس.


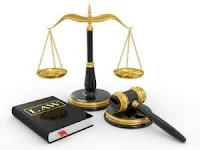




.jpg)





.jpg)






.jpg)



.jpg)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
فضلاً وليس أمراً
اترك تعليقاً هنا